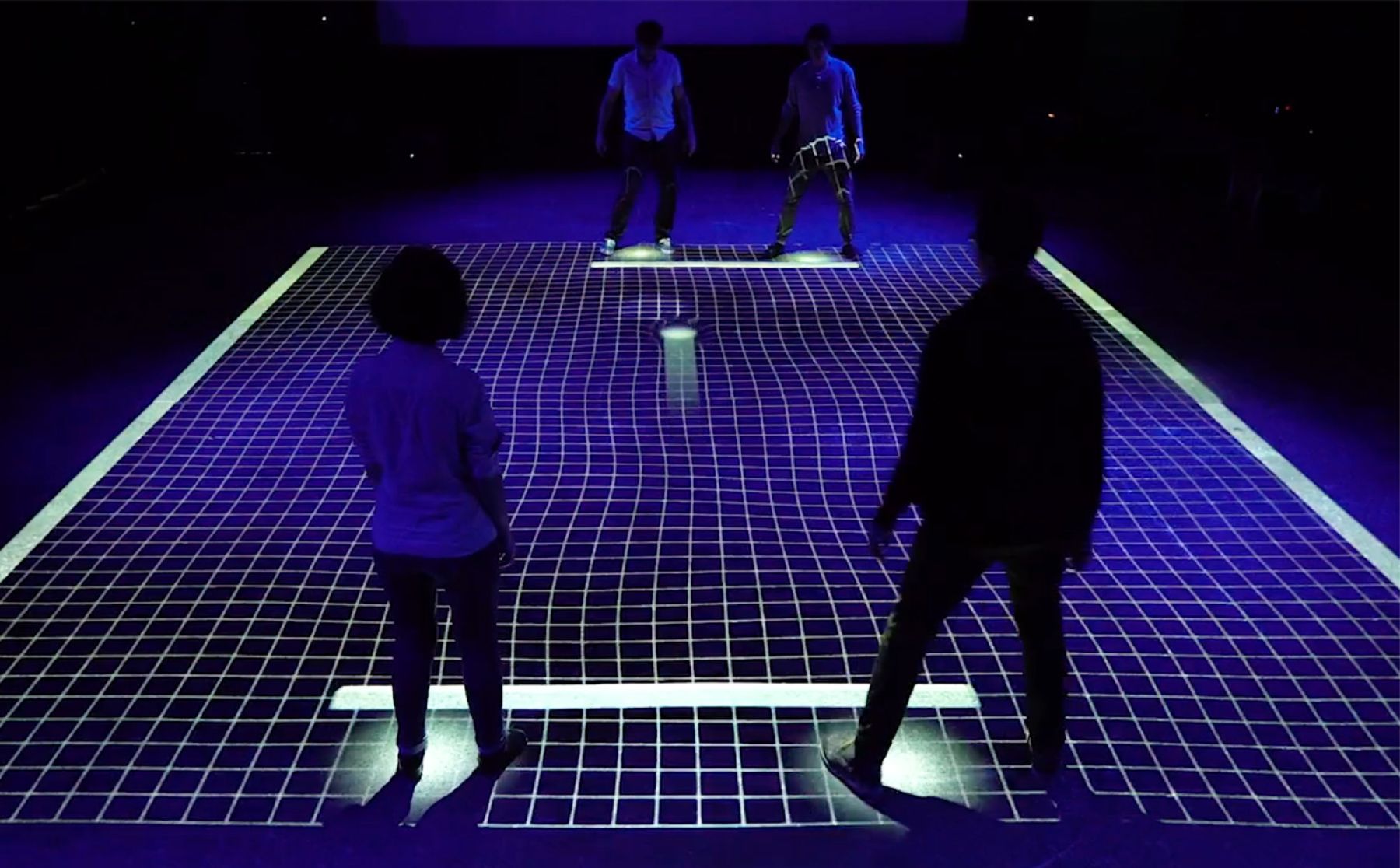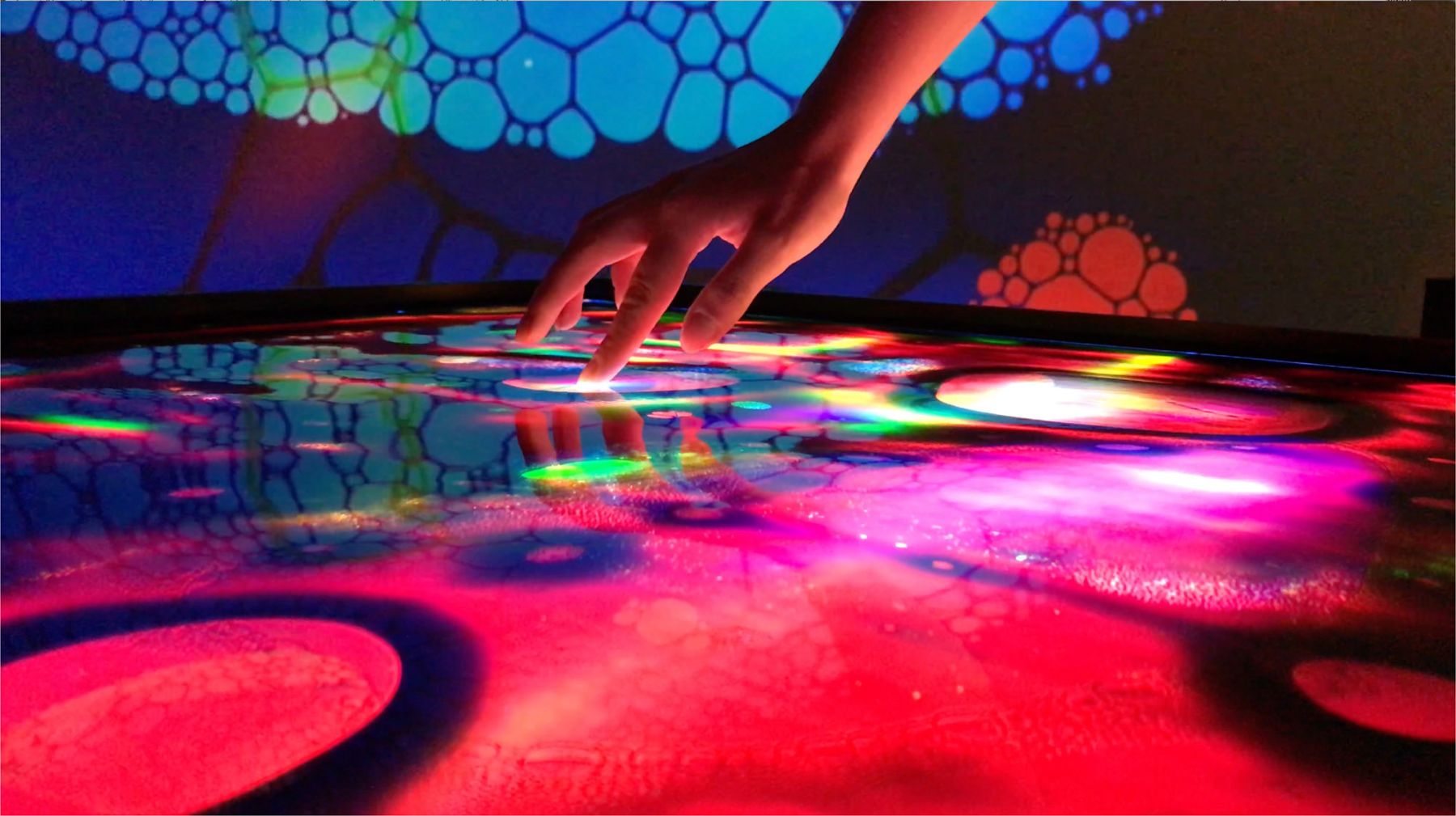"هو الذي رأى كل شيء في تخوم البلاد"..
بهذه العبارة/النبوءة تستهلُّ ملحمة جلجامش وصفها التراجيدي الشائق لبطلها الأسطوري المهموم بلغز الحياة، والباحث عن سر الخلود في الأرض بعد أن فُجِع بموت صديقه الأثير (أنكيدو)، ورأى ما صنعه الموت في محيّاه الجميل وملامحه الجليلة.
بدءاً من تلك اللحظة الفارقة كان على جلجامش أن يرحل بعيداً في عرض البلاد وطولها، وأن يتعرض في رحلته الممتدة لمِحن متوالية، وأن يقاوم بسفينته اليتيمة طوفاناً هائلاً ابتلع اليابسة لسبعة أيام متواصلة، ليرسو في آخر المطاف على الجزيرة التي سيتكشف له فيها بعض أسرار الحياة، فبعد أن استقر به المقام على أرضها "لمسه النومُ لمسَ الضباب"، فنام سبعة أيام متواصلة تآكلتْ فيها أرغفته السبعة، ليستيقظ بعد ذلك ذاهلاً ومفجوعاً بخسارته، وهنا يرثي لحاله (أوتنابشتيم)، ويبوح له بسر الخلود، مشيراً إلى "نبتة تشبه الشوك، وهي كالوردة يخزُّ شوكُها يدك"، فيغوص جلجامش لينتزع بيده هذا الشوك الورديّ، أو هذه الوردة الشوكية، فرِحاً بخلاص البشر أخيراً من عقدة الفناء، ولكنه في طريق عودته الظافرة إلى وطنه (أوروك) يلتهي يوماً بالاغتسال بالماء، ويدع النبتة الخالدة على الأرض، فتتسلل أفعى نحوها وتستحوذ عليها، وهكذا يتهاوى حلم جلجامش في لحظة واحدة أمام ناظريه، ويدرك متأخراً أن قلبه نزف دماً لا من أجل نفسه، ولا من أجل البشر، بل من أجل "أسد التراب"، كما كان البابليون يصِفون الثعبان.
في أدبنا العربي ستصادف ملامح جلجامش تتجسد باستمرار في قصص كثير من شعرائه وأبطاله؛ ولكنك لن ترى هذه الملامح تتجسد أوضح ما تكون كما تجسدتْ في حياة حامل لواء الشعر منذ فجره المبكر: امرئ القيس بن حُجر الكِندي، بدءاً من أسمائه المتعددة والألقاب التفخيمية المترادفة التي أطلقها العرب عليه، إذْ تداول الرواة ثلاثة أسماء له، فهو عندهم حيناً: (عدي)، وهو في حين آخر: (مُليكة)، وهو أيضاً: (حُندج)، والحندج في اللغة هو: الرمل الذي ينبت ألواناً، وكذلك كانت حياة امرئ القيس التي انتثرتْ: ورداً ودماً على رمال الصحراء، وتقلبتْ بين اللهو والجِد، والنعيم والبؤس، ورخاء البطالة والغزل، وسعير الحرب والانتقام، فاصطبغتْ بكل ألوان الطيف، وامرؤ القيس هو كذلك: (أبو وهب)، كما أنه أيضاً: (أبو الحارث) بما تحمله هذه الكنية الافتراضية -لأن امرأ القيس لم يُنجب أبناء- من دلالة وجودية على قدَر الإنسان من حيث هو حارث هذه الأرض الذي لا يكاد يملّ، وشاعرنا أيضاً هو: (الملك الضلّيل) الذي قضى شطر حياته الأول مُضِلاً للغواني ولرفاقه في اللهو، ثم قضى شطره الآخر ضالاً بين أحياء العرب وقبائلها، ومدن العجم وبطارقة الروم، طلبا لثأرٍ لا يُروى ظمؤه، ثم هو أخيراً: (ذو القروح)؛ لأن قيصر الروم –كما تقول الروايات- أرسل إليه بعد أن شكّ في ولائه حُلّة مسمومة، فلمّا لبسها سرى السمُّ فيه، وتقرّح جسده، ليموت غريباً بأنقرة وهو يرنو لقبر امرأة من بنات ملوك الروم، فيدرك أخيراً وحدة الإنساني فيه وفيها، حين ساوى الموت بينهما في المصير:
أجـارتنا إنّ المـزار قريبُ وإني مُقيمٌ ما أقام عسيبُ
أجارتنا إنّا غريبان هاهنا وكلُّ غريبٍ للغريبِ نسيبُ
أدرك هذه الحقيقة الإنسانية الأولية بعد أن لبِس الحُلّة المسمومة وشارف الموت، كما أدرك جلجامش هذه الحقيقة نفسها بعد اغتساله بالماء وضياع نبتة الخلود من بين يديه.
ونرى ثانياً هذه الملامح الجلجامشية تتجسد في تلك الأساطير التي نسجتْها مخيّلة أمّة كاملة حول حياة امرئ القيس وتاريخ أسرته الملكية، وحول شبابه اللعوب ومغامراته العابثة، وقصص لهوه المتصابي، وأشهرها: حكاية يوم الغدير ودارة جُلجُل التي طالما حبستْ أنفاس السامعين في ليالي السمر منذ أن رواها الفرزدق لنسوة الغدير في البصرة، ثم نسج الرواة ما نسجوا من قصص أخرى لا تخلو من رهبة الغموض وحيرة الألغاز، وقد حكى الأصفهاني في (الأغاني) جانباً منها؛ كلغز (الثمانية والأربعة والثنتين) الذي كان يمتحن به امرؤ القيس المرأة التي يرغب في الزواج بها، ومثله كذلك لغز (المرأة التي تشقّ النفس نفسين) الذي لم يستطع أن يفسره سوى امرئ القيس نفسه .
تستقبل هذه الروايات الأسطورية المتتابعة، ثم يُعرض أمامك بعد ذلك كله المشهد الأسطوري الأكثر هيبة: مشهد صدمة امرئ القيس وسط مجلس سمره وخمره بنبأ مقتل أبيه: الملك حُجر على يد بني أسد، وعبارته المريرة المدوية التي ذهبتْ مثلا: (ضيّعني صغيراً، وحمّلني دمه كبيراً، لا صحو اليوم، ولا سُكْر غداً، اليوم خمر، وغداً أمر).
ولم يقف النسج الأسطوري عند تفاصيل حياة امرئ القيس الشخصية، بل راحت الروايات تنسج حياة موازية تدور أحداثها حول صاحبه من الجن، فذكروا أن اسمه: لافظ بن لاحظ، وأنه يسكن في خيمة منعزلة وسط صحراء مترامية لا يصل إليها إلا المنقطعون من البشر، وقد راح ذات يوم يتبجح أمام ضيفه الإنسيّ المرتعد في وحشة الصحراء بأنه هو الذي كان يُمد امرأ القيس بهذا الشعر الساحر المتجاوز لقدرة البشر على التصوير والتخييل !
كما نرى هذه الملامح البطولية ثالثاً في الأوليات التي اختُص بها امرؤ القيس من بين شعراء العرب قاطبة، فهو –كما يردد الشراح والنقّاد- أول من وقف واستوقف، وبكى الأطلال واستبكى عليها، وموّجَ الليل، وقيَّد الأوابِد، وهو الذي خسف للشعراء عين الشعر، وسبقهم إلى المعاني المخترعة، والأخيلة المبتكرة، وافتضّ أساليبَ تعبيرٍ تحوّلتْ بعده إلى أعراف تُحتذى، وتقاليد فنية يُنسج على مِنوالها، ولطالما نسبتْ الأمم أولياتها إلى أبطالها الأسطوريين.
ثم نرى هذه الملامح الأسطورية رابعاً في هذا التطواف (السندبادي) الذي طبع حياة امرئ القيس، وخاصة في طورها الثاني، أي بعد المصير الدامي الذي حلّ بأسرته الملكية: بدءاً بمقتل جدّه الحارث، ثم أعمامه الملوك، وانتهاءً بمقتل أبيه: حُجر، وهو التطواف الذي دفعتْ إليه الرغبة العارمة في الثأر والانتقام، ومن هنا نصادف في شعره أسماء مواضع بعيدة ومدن خارج الجزيرة العربية مثل: بعلبك، وحمص، وحوران، وحماة، وشيزر، وأنطاكية، وأنقرة، وهو القائل:
وقد طوّفتُ في الآفاق حتى رضيتُ من الغنيمة بالإيابِ
وحتى تكتمل أركان الأسطورة فإن رغبة امرئ القيس في الانتقام من قتلة أبيه لم يكن لها حد تقف عنده، فقد استمر يطلب النصرة من قبائل العرب، ويحشد الجيوش المتتابعة ليُغير على بني أسد، ويطارد فلولهم أينما حلّوا، مواصلاً الليل بالنهار، ومنفّراً الطيور عن أعشاشها وقت السكون، حتى ليشعر صاحبهم المتوجس: عِلباء بن الحارث الأسدي بحرارة أنفاس هذا الموتور المنتقم تكاد تلفح وجهه، فيرسل عبارته التحذيرية التي صارت مثلاً: (لو تُرِك القطا ليلاً.. لنام) !
وقد تحقّق له الانتقام من بني أسد أكثر من مرة، ولكنه لم يكتفِ من دمائهم، كأنما تحوّل الانتقام عنده إلى هَوَس مقصود لذاته، وسرعان ما ملّت القبائل التي ناصرتْه في البدء وانفضّتْ عنه، فلم ييأس من المطالبة بثأره، بل راح يستدعي النصرة من خارج الجزيرة العربية في تطواف أوصله –كما تذكر الروايات- إلى قيصر الروم في القسطنطينية، وبينما كان يقطع الفيافي الشاسعة على ناقته الأثيرة برفقة صاحبيه كان يذكِّر نفسه بإرثه الملَكي السليب، ومسعاه الطَّموح:
عليها فتى لم تحملِ الأرضُ مِثْلَه أبَــرَّ بـمِيثاقٍ وأوفَـى وأصبرا
ولو شاء كان الغزْو من أرضِ حِـمْيرٍ ولكنّه عمْداً إلى الرومِ أنْفَرا
بكى صاحبي لـمّا رأى الدربَ دونهُ وأيقنَ أنَّا لاحقانِ بِقيصرا
فقلتُ لـه: لا تـبْـكِ عينُك إنّما نُحاولُ مُلْكاً أو نموتَ فنُعذَرا
هكذا تحوّل والده حُجر إلى (أنكيدو) آخر يحرّض المتعلّق به ضد فكرة الموت نفسها، وضد القبول بها والتعايش معها كمسلَّمة بديهية، وكأنما أراد امرؤ القيس من خلال هذا الانتقام المتسلسل والمتواصل من قاتلي أبيه أن يضع أصبعه في عين الموت مباشرة، ليقتلعها قُرباناً لأبيه المغدور، هذا مع إدراكه لسطوة الموت الشاملة التي حوّلتْه هو نفسه إلى أداة من أدواتها لزرع القتل وحصد الأرواح واستشراء التوحش، ربما من أجل هذه المفارقة قال هذا المناضل بالموت ضد الموت في لحظة صدق متجلية:
أرانا مُوضِعيـن لأمر غيبٍ ونُسحَر بالطعام وبالشرابِ
عـصـافـيــر وذِبّـان ودُودٌ وأجرأُ من مجلّحة الذئـابِ
إلى عِرق الثرى وشجتْ عروقي وهذا الموت يسلبني شبابي
ونفسي سوف يسلبها وجِرمي فيُلحقني وشيكـاً بالترابِ
لقد أيقظه مقتل والده حُجر من غفوته الناعسة في أحضان الحس وصبوات الجسد ليختبر صحوة التفكُّر المرير، ولعله أدرك متأخراً أن لهاثه القديم خلف المغامرات العابثة والمتع الحسية لم يكن سوى ذريعة مؤقتة للهروب من مواجهة أسئلة الوجود المقلقة، وللتشويش على رؤيةٍ ستكدِّر خاطره لو صفتْ، واستبانت له تفاصيلها الفاجعة.
ولكنّ صحوة التفكُّر المرير لن تمنعه من اجتراح قدَره بنفسه، ومواجهة مصيره أياً تكنْ عواقبه، وهذا العنفوان الحاسم في مواجهة الموت سنجد جذوره متغلغلة عميقاً في العائلة، فالروايات تذكر أن شقيقي والدة امرئ القيس (فاطمة) هما: كُليب، ومهلهِل سيدا قبيلة تغلب، فمِن هذه الخؤولة ربما تسرّبتْ إليه أنفة كُليب، وسرى في دمائه عنفوان مُهلهِل وهو يردد بعد مقتل أخيه شرطَه التعجيزي أمام القتلة: (يا لبَكْرٍ أنشِروا لي كُليباً)، فحتى يكفّ هذا الأخ الموتور عن مواصلة الثأر والانتقام كان على قبيلة بَكْر أن تُعيد أخاه كُليباً إلى الحياة من جديد !
في المقابل كان يفتقر إلى هذا العنفوان الأسطوري ابنُ ملكٍ آخر فُجِع مثل امرئ القيس بمقتل والده، ولكنه تصرّف أمام الفجيعة على نحو مختلف، إنه (هامْلت) الشكسبيري، فقد كبّله موقفه الأوديبيّ المتردد إلى حد التخاذل، بعدما تكشّفتْ له خيوط المؤامرة المحبوكة ضد والده من أقرب الناس إليه. هكذا بدا أنّ ظِلّ الموت كان أشدّ رعباً وسطوة على هاملت، فلم يستطع أن يرتقي –في المنظور التخييلي- لمستوى الحدث الكوني الذي ارتقى إليه هؤلاء الأبطال الأسطوريون: امرؤ القيس، ومهلهِل، وجلجامش.
بقلم د. سامي العجلان