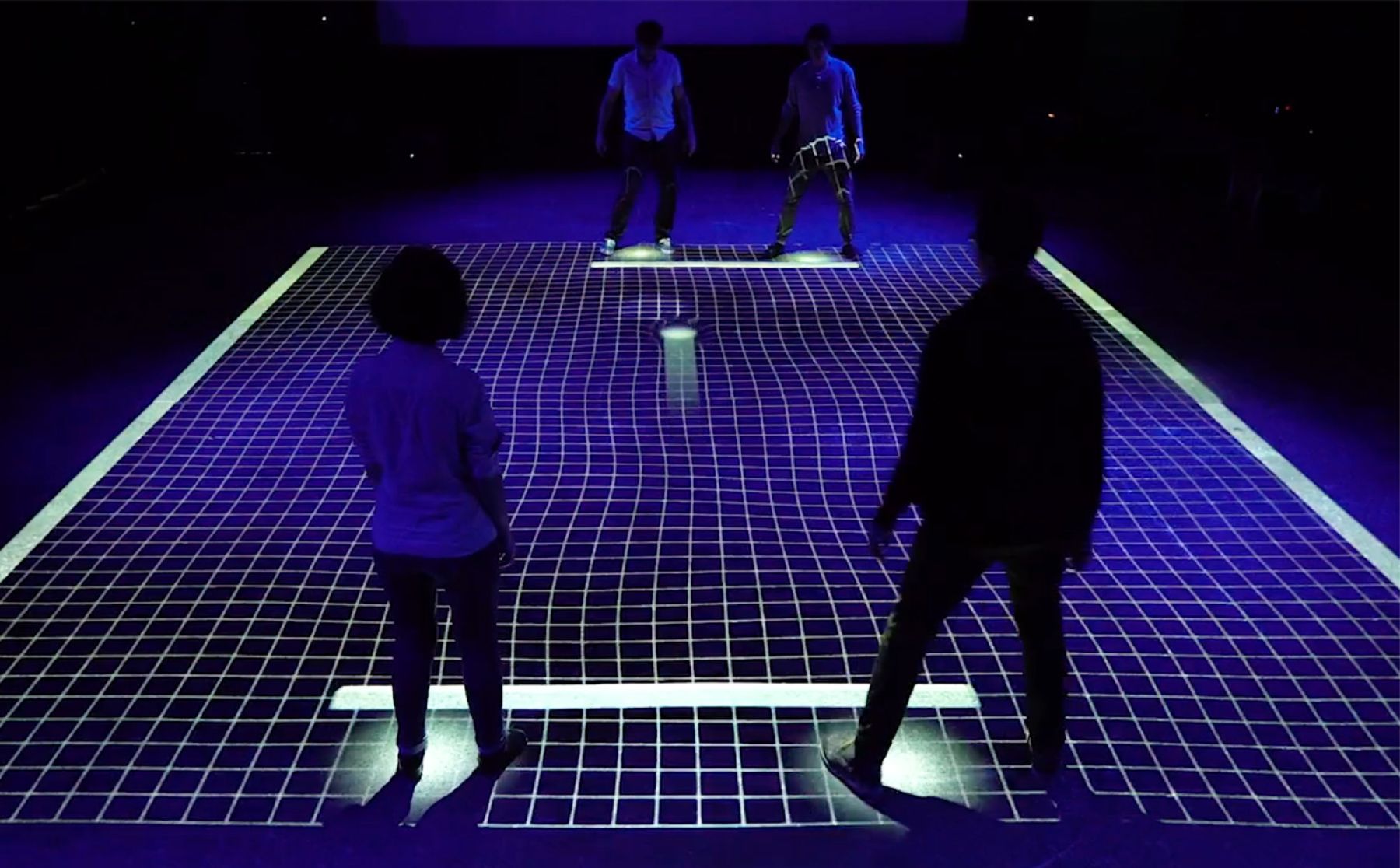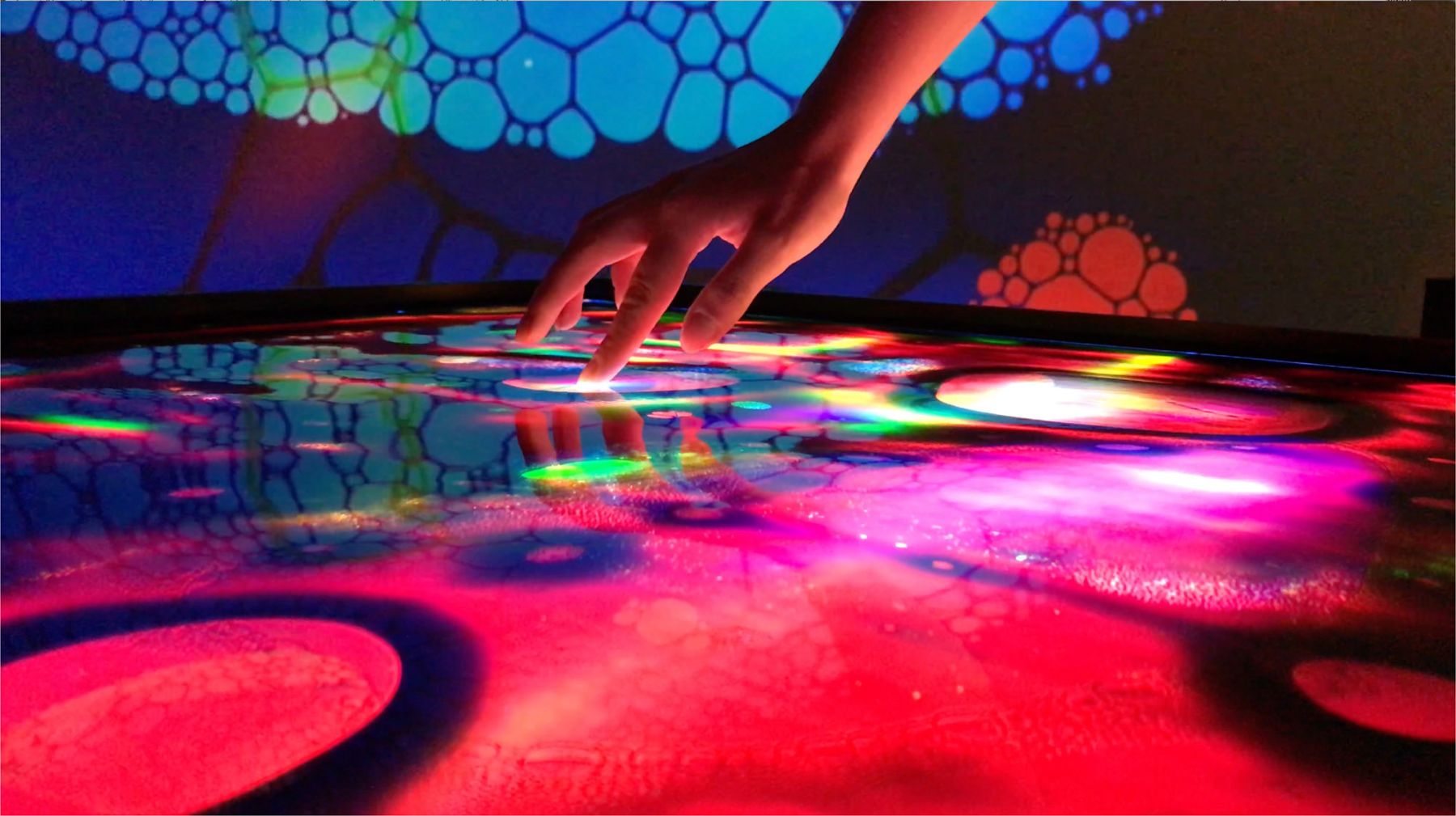عندما يكون الحبر ترياقًا
عبر العصور، ظل الأدب بمفهومه الواسع، والفن بمفهومه الأوسع، عالمَين موازيين للواقع، يتماهيان معه، يستندان إليه، يأخذان منه وحتى يتأثران به ويؤثران فيه أحيان كثيرة. فقد خلّد الفنانون التشكيليّون، والمخرجون السينمائيون، والنحاتون اللحظات البهيجة السعيدة، واللحظات الحرجة الحزينة من تاريخ البشرية، في أعمال فنية ما زال بعضها خالدًا في المتاحف والشوارع والمعابد وذاكرة السينما؛ غير أن الكتًاب كانوا دائمًا الأكثر قدرة على تخليد وقائع الكون، بكثير من الواقعية الممزوجة بالخيال؛ ولَم تكن الأوبئة التي ضربت كوكب الأرض ووضعت الإنسان أمام تحدي البقاء، بمعزلٍ عن أقلام الكتّاب، بل يمكننا القول إن من بين الحسنات القليلة للأوبئة، أنها ألهمت الكتّاب وغذت المكتبة العالمية بأرشيفٍ سرديٍّ عظيم.
فقد أودعَ ألبير كامو كاملَ طاقته في روايته الأبرز "الطاعون"، فعندما بدأت الجرذان النافقة تملأ الشارع والنَّاس يواصلون الموت دون توقف، كان لا بد أن تعزل وهران عن المحيط الخارجي، وأن يواجه سكانها الموت عزَّلا إلا من طبيبٍ شجاع، وشحنات من إرادة الحياة تدب فيهم من حينٍ لآخر، ولا يتحدث كامو عن واقع، بل عن سلسلة من الإسقاطات ذات الأبعاد التاريخية والاجتماعية والسياسية، عن مدينته التي أحبها حد الوجع.
بينما يسلك غابريل غارسيا ماركيز طريقًا مختلفا، حيث كتب رواية حب صافية، ذات زمنٍ طويل يؤرخ الحب ولكنه يمر على كل التغيرات في منطقة الكاريبي؛ ولكي يحظى الحبيبان بتجسيد حبهما معًا في "الحب في زمن الكوليرا"، كان على العاشق السبعينيِّ، الذي ربى حبه نصفَ قرن دون ملل، فلورنتينو، أن يعمد إلى خدعة بسيطة وهي رفع علم الكوليرا على سفينته كي تظل بمعزلٍ عن موانئ العالم ولا تزورها إلا لتتزود بالوقود، وقد انطلت الخدعة لوقتٍ طويل ولكنها تنكشف أخيرًا، وتتوقف السفينة عن الإبحار، ولكن الحب لا يتوقف.
فيما جسّد الكاتب البرتغالي جوزيه ساراماغو إحدى أكثر الروايات شاعرية و إنسانية، من خلال تتبعه للعمى في روايته الأشهر، التي تحمل الاسم ذاته، فعندما يصاب الجميع بالـ"بياض المشع"، كنايةً عن فقدان البصر، سوى امرأة واحدة تنجو، وربما يكون وجودها المبصرُ في مجتمع يسوده العمى هو لب الرواية، وسؤالها الفلسفي الغرائبي الرئيسي.
عشرات الروايات الأخرى تطرقت للأوبئة، أثارت غبار الأسئلة و أحيت الجانب الإنساني الجمعي حينًا، والجانب الذاتي الشخصي حينًا آخر حسب رؤية كل كاتب، و موقعه من الأحداث، ولا يمكننا إلا أن نتذكر هنا أكثر الكتابات القصصية التصاقًا بالواقع وتشخيصا له عندما نتحدث عن الأوبئة في الأدب السردي، إنها "ديكاميرون" للكاتب والشاعر الإيطالي جيوفاني بوكاتشو؛ حيث يحكي في مائة قصة، كيف يقضي عشرة أشخاص حياتهم داخل فيلا معزولة في ضاحية فلورنسا، محاولين قضاء وقتهم في التنكيت ونسيان أو تناسي أن الطاعون يفتك بالبشر في الوقت نفسه خارج منزلهم المعزول.
وتقرأ لنا الروائية الكندية إيميلي مانديل ماذا حدث بعد الإنفلونزا الجورجية من خلال روايتها ذائعة الصيت "المحطة الحادية عشرة"؛ ويأخذنا الكاتب الأمريكي جاك لندن في جولة حول الحمى النزيفية، من خلال روايته المتشائمة جدًا "الوباء الوردي"؛ وتكتب ماري شيلي عن الوباء الأكثر حضورا في تاريخ البشر، الطاعون، من خلال روايتها "الإنسان الأخير".. وعلى ذكر شيلي، فإننا لا نجانب الصواب إذا استحضرنا روايتها العظيمة التي أثرت في أدب الرعب"فرانكنشتاين"، فما كانت هذه الرواية لترى النور لولا العاصفة الثلجية التي ضربت العالم سنة 1816م،
والتي فرضت على الكاتبة المكوث حبيسة المنزل، مما حدا بها إلى كتابة فرانكنشتاين.
الأدب لا ينقل الواقع فقط، ولكنه أيضا يتنبأ بالمستقبل أحيانًا، ولا أدل على ذلك من عديد الروايات والقصص القصيرة التي نقرأ فيها ما يشبه تنبؤًا بالكورونا الذي يضرب العالم في الوقت الراهن؛ فحين نقرأ الوباء الذي وصفه نجيب محفوظ في رائعته "ملحمة الحرافيش"، ندرك أنه يصف شيئا يشبه من نمر به هذه الأيام؛ وقد تجاوز الدكتور أحمد خالد توفيق، الرائد في كتابة روايات الخيال العلمي، الخيالَ كثيراً ليسمي الوباء باسمه "كورونا"، في كتابه المنشور قبل ست سنوات "شوربة الحاج داوود".
الكتّاب ليسوا متفرجين على ما يحدث، إنهم يفعلون ما يستطيعون لينقذوا العالم، لينقذوا أنفسهم، يفعلون ما في وسعهم ليتعافى العالم بعد الأزمة وليتعافوا هم أنفسهم، يفعلون ما يستطيعون فعله، ما يتقنون فعله.. يكتبون. يطلقون رصاص كلماتهم ترياقًا في وجه الكوارث.