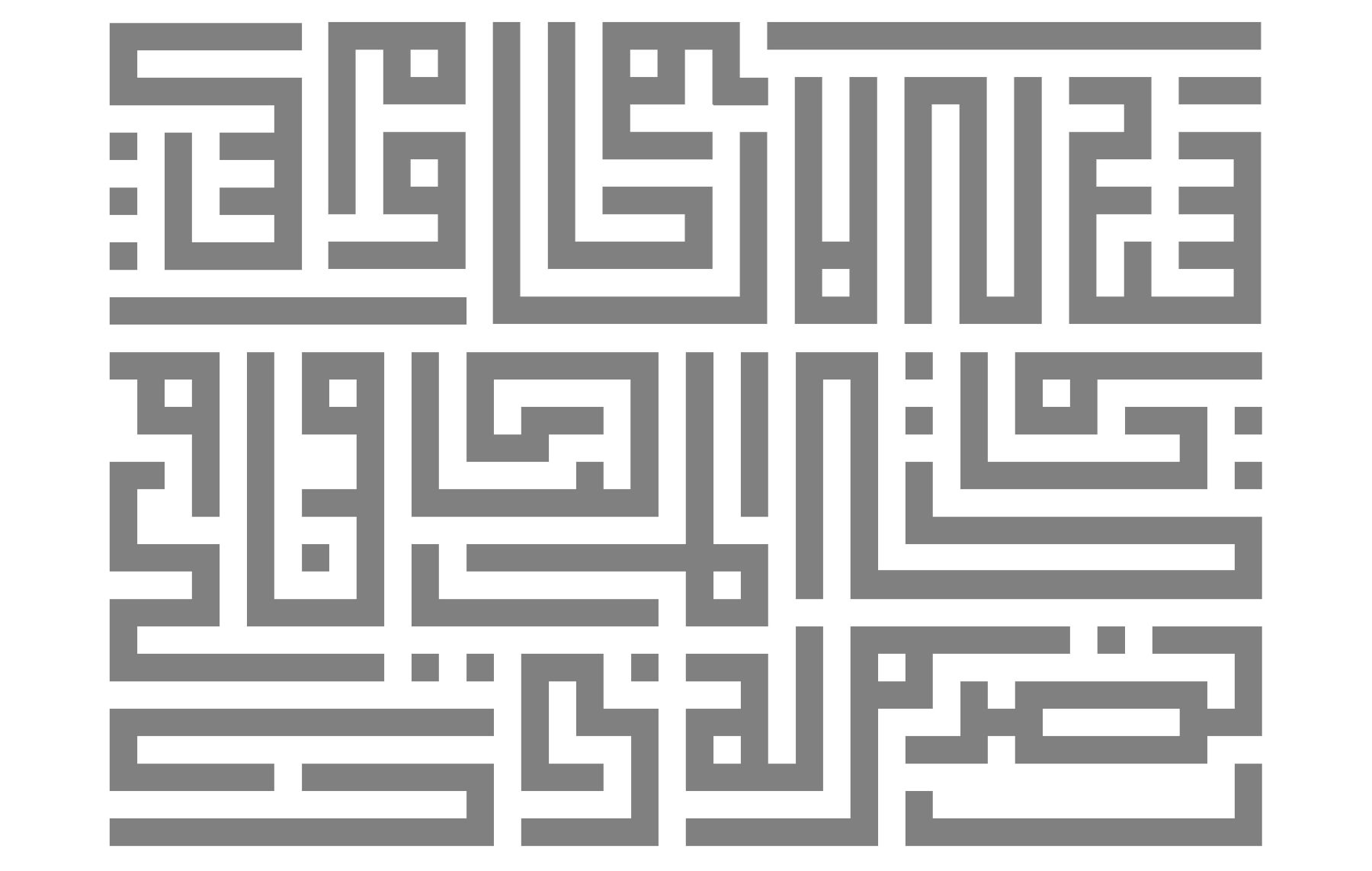صور غريبة ومضطربة يتم تقديمها كنموذج للرجل الشرقي، والعربي خصوصاً، الابن التلقائي للصحراء، بكل قسوتها وحدتها في الطباع والأمزجة والقسمات. وهي ليست محض لقطات خياليّة عابرة من أحد فصول ألف ليلة وليلة، ولكنّها الصورة التي تنظر بها كثير من مجتمعات العالم اليوم، لا سيما الغربيّة منها، إلى جزء كبير من حضارة الشرق. ولئن كانت بصمات الإعلام واضحة في تضخيم هذه الصورة وترسيخها في الأذهان، فإنّ تنميط الآخر وحصره في "كليشيهات" لا تقبل النقد يبقى سلوكًا بشريًّا، كثيرًا ما كان حاضرًا منذ الحضارات الأولى وحتى الآن. وإنّ السؤال ليطرح نفسه بشكل أكثر إلحاحًا في زمن الانفتاح الثقافيّ ورقمنة الحضارات: كيف صمدت ظاهرة التنميط أمام ماكينة الاندماج الثقافيّ التي تأتي على الأخضر واليابس؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه الظاهرة أن تشكل صلصال الوعي العالميّ في اتجاهات أبعد ما تكون عن التلقائية؟
مفهوم الكليشيهات نفسه بقي متأرجحًا بين سلوكين، يتقاربان في الممارسة، ويختلفان في الحيثيات: التعميم، والتنميط. فإذا كانت نقطة التقاء هذين المفهومين هي النظر من زاوية خاصّة إلى مجموعة من البشر، وتكوين تصوّر محدد عن هذه المجموعة، فإنّهما يختلفان في أنّ التعميم يكتفي بنسب خصائص متشابهة إلى أفراد مجموعة ما بشكل عام، دون التورط في إسقاط التعميم على جميع هؤلاء الأفراد، أو إلغاء إمكانيّة اختلافهم فرديًّا، كالرأي السائد بأنّ الشخصيّة الغربيّة تميلُ إلى طرق التواصل المباشر، وتطغى عليها الفردانيّة، على عكس الشخصيّة الشرقيّة التي تميلُ إلى التواصل غير المباشر وتطغى عليها الجماعيّة والحساسيّة للسياق، بينما يفرض التنميط، من جهته، معتقدات مشتركة حول السمات الشخصيّة لأفراد المجموعة، ويسقط هذه الصورة النمطيّة على كل فرد منهم.
تتعدد أشكال التنميط بتنوع المجموعات التي يتعلّق بها، إذ نميّز التنميط الفئوي المرتبط بفئات محددة من الناس، كالقول بأنّ كلَّ الشقراوات محدودات الذكاء، وكلّ المراهقين متمردون، ونجد أيضا التنميط الجنسيّ الذي يفترض ـ على سبيل المثال ـ أنّ كلّ النساء عاطفيّات، وأنّ كلّ الرجال فوضويّون، أو أنّ الأعمال الشاقة تخصّ الرجال فقط. ويبرز أيضا التنميط العرقيّ من خلال مقولات من قبيل: كلّ السود أقوياء البنيّة، أو كل الآسيويّين لا يأكلون إلا الأرز. التنميط الثقافيّ كذلك حاضر بكليشيهاته الملتصقة بشعوب وثقافات مختلفة، فالفرنسيّون كلّهم عاشقون رومانسيّون، والمكسيكيون مهاجرون غير شرعيّين، والمسلمون متشددون، واليهود جشعون.
ورغم أنّ الضوء قد سُلّط على فكرة التنميط بشكل أكبر في العقود الحاليّة ـ نظرًا لوجود أدوات التأثير وتطور تقنياته ـ إلا أن الممارسة نفسها قديمة قدم الحضارات الإنسانيّة، إذ كان الرومان على سبيل المثال يعتبرون الشعوب الأخرى من البرابرة، وكانت الصورة السائدة عن الإغريق أنّهم جميعًا من الشقر. لم تسلم المرأة من التنميط، بل كانت دائمًا من أهم ضحاياه، ففضلًا عن النظرة الدونيّة التي ظلت لقرون مسلطة عليها، كانت هناك دائمًا كليشيهات جاهزة لإسقاطها عليها، ولعلّ من أشهرها الفكرة القروسطيّة القائلة بأنّ كلّ امرأة دميمة أو عانس أو غريبة الأطوار ساحرة. وبمرور الزمن وتطور النزعات القوميّة وكثرة الاحتكاكات بين الشعوب، خرج التنميط من حيز الفئة والجنس والعرق، إلى فضاء الكليشيهات الثقافيّة الرحبة، وأصبح يتناول الآخرَ الذي كان خارج المشهد من قبل. فخلال القرن السادس عشر ساد التصوّر بأنّ كلّ الألمان سكّيرون وثقيلو الفهم، وفي القرن الثامن عشر كان يُنظَرُ إلى الإنجليزيّ باعتباره كئيبًا وكارهًا للناس.
هذا الجنوح المستمر إلى تكوين صورٍ نمطيّة مشتركة وإسقاطها على الآخر يستدعي التساؤل عن أسبابه ومصادره. وفي الواقع تتعدد أسباب التنميط وتتفرّع إلى أسباب معرفيّة ونفسيّة واجتماعيّة، وحتى حضاريّة. فعلى الصعيد المعرفيّ، يتعلق الأمر بآليّة عمل الدماغ البشريّ، الذي يبتعد دائمًا عن المستويات المعقّدة، ويميل إلى تبسيط المعلومات، ووضعها تحت خانات موحدة ومبسطة تنصهر داخلها الفروق والاختلافات. كما يمكن تفسير التنميط من زاوية نفسيّة، بأنّه: الرغبة اللاواعية في الشعور بمعرفة الآخر وتفكيك المجهول. فالإنسان عدو ما يجهل، وكثيرًا ما يكون التنميط هو السلاح الذي يستخدمه اللاوعي لتبديد المخاوف المتعلقة بذلك المجهول، وتحويله ـ ولو بشكل غير معمق أو غير ناضج ـ إلى صورة يألفها الذهن ويستكين لها. ويمثل المجتمع بدوره مجالًا خصبًا لازدهار الكليشيهات، اعتمادًا على الرغبة الفطريّة لدى الفرد في الانتماء إلى المجموعة، والمبالغة في إظهار التشابه بين أفرادها، التي تؤدي حتمًا إلى البحث عن إبراز الاختلاف بين هذه المجموعة وغيرها من المجموعات، فتظهر التصنيفات التي تعزّز فكرة تلك الاختلاف. ولا شكّ أنّ صراع الحضارات يبقى من أبرز مصادر التنميط، ومن أقوى أسباب ترسّخه واستمراره في الزمن، ولعلّ الاستشراق يفرض نفسه مثالًا، تستمر تداعياته إلى اليوم، على سعي الحضارة الغازية إلى قولبة الحضارة المستهدَفة، وحصرها داخل صورة نمطيّة تستولي على الإدراك الجمعيّ، وتفرض نفسها على مساراته.
ولا شكّ أنّ ظاهرة بهذه القوة وهذا الترسخ في العقل اللا واعي الجماعي، لها من التداعيات والآثار ما يستوجب الوقوف والتأمل. ورغم الجوانب الإيجابيّة ـ ظاهريًّا ـ للتنميط بمختلف أشكاله، والتي لا تحجب آثاره السلبيّة أوتقلّل من وطأتها، فإنّ التنميط الإيجابيّ يحمل في باطنه من السلبيّات، ما يتجاوز التنميط السلبيّ في حجم الضرر الذي يلحقه بالأفراد والمجتمعات. تؤثر الكليشيهات السلبيّة المرتبطة بمجموعة من الناس على الصورة العامة التي ينظر الآخرون إليهم من خلالها، ولكنّها قلما تؤثر فيهم داخليًّا، بل تكتفي بتسليط بؤرة النظرة السلبيّة، والتنمّر الجماعيّ، والعنصريّة عليهم، إلا أنّ التنميط الإيجابيّ لمجموعة من الناس ـ وإنّ كان في ظاهره يخلق صورة مشرقة لأفرادها ـ يحصرهم في مربع الالتزام بتلك الصورة وتجنب القيام بما يخالفها، ويكبّلهم تحت الضغوط الذاتيّة، ويخلق توقعات وانتظارات غير واقعيّة، وصعبة التحقيق، فالمرأة التي تريد ممارسة الرياضة ـ والعضليّة خاصة ـ ستمنعها قيود الصورة النمطيّة الإيجابيّة، عن رقة الأنوثة ووداعتها، من الانتقال إلى ذلك المربع المخصص، نمطيًّا، للرجل وحده، والياباني الذي ينتظر منه الجميع أن يحيِّيَهم بانحناءة احترام، سيصعب عليه أن يخالف تلك التوقعات متى أراد ذلك. وبين مظاهره الإيجابيّة والسلبيّة، يبقى التنميط سلوكًا ذهنيًّا معرقلًا للتطور الطبيعيّ للإنسان، وشكلًا من أشكال التمييز المسلط على فئات دون غيرها.
وفي خضم هذه التداعيات التي فشلت في الاحتفاظ بوجهها المشرق، نجد أنفسنا أمام حتميّة التعامل مع هذه الظاهرة، وإيجاد الكيفيّة اللازمة لذلك. يتميز التنميط بطبيعته التصنيفيّة القائمة على أساس تقسيم المجموعات الكبيرة إلى مجموعات أصغر، حسب أصنافها الرئيسة والفرعيّة، ولا شكّ أنّ إعادة تصنيف هذه المجموعات ـ صعودًا من الأخصّ إلى الأعمّ ـ يمثل استراتيجيّة ناجحة للوصول إلى زوايا نظر جديدة، فإذا كانت الشقراوات غير ذكيّات، فإنّ النساء عمومًا كذلك، وإذا كان الألمان غير ودودين فقد يكونون كذلك إذا نظرنا إليهم بوصفهم أوروبيّين. اعتبار الأشخاص أفرادًا لا أعضاء في مجموعة من شأنه أيضًا تخفيف القبضة الصارمة للصورة النمطيّة، وتمييع ملامحها. إلا أنّ كلّ هذا يبقى نظريًّا وهشًّا أمام المتغيّرات التي تهبّ رياحها باستمرار، إذا لم يتدعّم بتواصل مع الآخر، واستكشاف لحقيقته، بعيدًا عن الكليشيهات والتصنيفات الضيّقة. نحن اليوم أمام مفارقة جديرة بالتأمّل، فخصوصيّة هذا العصر، وثورة التكنولوجيا والاتصالات التي ترسم معالمه ـ والتي أسهمت في ترسيخ الصور النمطيّة، وتوثيقها، ورقمنتها، ومشاركتها على أوسع النطاقات ـ تخلق في كل يوم قنوات اتصال جديدة بين الثقافات، وتجعل السفر بينها ـ واقعيًّا وافتراضيًّا ـ متاحًا للجميع، وترسم مشهدًا جديدًا، قد لا يكون فيه مكان لصورة نمطيّة تحمل في داخلها التناقض بين السطح والعمق، وبين الفرضيات والحقائق، وبين الشكل والمضمون.